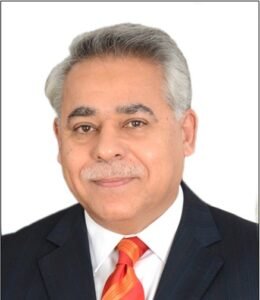 د. عصام البرّام
د. عصام البرّام
ليس أدب المهجر مجرد نصوص كُتبت خارج حدود الأوطان، ولا هو حنين عابر إلى أماكن بعيدة، بل هو تجربة إنسانية عميقة تشكّلت في منطقة متوترة بين الفقد والاكتشاف، بين ما كان وما صار، وبين وطن يسكن الذاكرة وواقع جديد يفرض حضوره اليومي. إنه أدب وُلد من الاغتراب، ونما في تربة الصراع الداخلي، حيث تتنازع الهوية جذورها الأولى وأغصانها الجديدة، وحيث يصبح الحنين فعلاً إبداعياً لا يقل قوة عن الكتابة ذاتها.
ظهر أدب المهجر نتيجة موجات الهجرة العربية، خاصة في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، حين دفعت الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية كثيراً من المثقفين إلى الرحيل نحو الأميركيتين وأوروبا. لكن الرحيل الجغرافي لم يكن نهاية الانتماء، بل بدايته بشكل آخر. فالمهاجر حمل وطنه في لغته، وفي ذاكرته، وفي قلقه، وراح يعيد تشكيله بالكلمات، وكأن الكتابة أصبحت وطناً بديلاً، أو جسراً هشاً يصل بين ضفتين متباعدتين.
في قلب أدب المهجر يتجلى صراع الهوية بوصفه سؤالاً مفتوحاً لا يبحث عن إجابة نهائية. المهاجر لا هو ابن الوطن الأول بالكامل، ولا هو مندمج كلياً في الوطن الجديد. يعيش حالة بينية، معلّقة، تجعله ينظر إلى ذاته وإلى العالم بوعي مزدوج. فهو يرى وطنه القديم بعين النقد والحنين معاً، ويرى وطنه الجديد بعين الإعجاب والحذر. هذا التمزق الداخلي انعكس بوضوح في النصوص المهجرية، حيث تتجاور الرغبة في التحرر من قيود الماضي مع الخوف من الذوبان في الآخر.
الهوّية والأدب
الهوية في أدب المهجر ليست معطى ثابتاً، بل كياناً متحولاً، يعاد تشكيله باستمرار. فاللغة، على سبيل المثال، تصبح ساحة صراع حقيقية. الكاتب المهجري يكتب بلغة الأم، لكنه يعيش في فضاء لغوي مختلف، ما يجعل لغته محمّلة بظلال جديدة، وبإيقاع مختلف، وبصور مستمدة من بيئة لم تكن مألوفة من قبل. هكذا تتغير اللغة دون أن تفقد جذورها، وتتجدد دون أن تنكر أصلها، في محاولة للتوفيق بين الانتماء والتجربة.
أما الحنين، فهو النغمة الأكثر حضوراً في أدب المهجر، لكنه ليس حنيناً بسيطاً أو ساذجاً. إنه حنين مركب، يحمل في طياته الألم والشك والأسئلة المؤجلة. فالعودة في النصوص المهجرية غالباً ما تكون حلماً مؤجلاً أو فكرة رمزية أكثر منها حدثاً فعلياً. يعود الوطن في الذاكرة كما كان، نقياً، ثابتاً، بينما الواقع في الداخل قد تغيّر، والذات نفسها لم تعد كما كانت. من هنا يتحول الحنين إلى حالة وجودية، لا تتعلق بالمكان فقط، بل بالزمن وبالذات القديمة التي لم يعد بالإمكان استعادتها.
يتخذ الوطن في أدب المهجر صورة الأم البعيدة، الحاضرة في الوجدان رغم الغياب. فهو مصدر الدفء الأول، ومخزن الطفولة، ومسرح الذكريات الأولى. لكن هذا الوطن لا يظهر دائماً بصورة مثالية، إذ كثيراً ما يُستحضر مقروناً بالخذلان أو القسوة أو التضييق الذي كان سبباً في الرحيل. هذا التناقض يمنح النص المهجري عمقه الإنساني، ويبعده عن الخطاب العاطفي السطحي، ليجعله مساحة اعتراف ومساءلة في آن واحد.
في مقابل الوطن الأول، يبرز الوطن الجديد بوصفه فضاءً للفرص والحرية، لكنه أيضاً فضاء للغربة والعزلة. فالاندماج في مجتمع مختلف ثقافياً وحضارياً يفرض على المهاجر إعادة تعريف ذاته باستمرار. يشعر أحياناً بأنه مرئي في اختلافه، وغير مرئي في إنسانيته. هذا الإحساس يتسرب إلى الكتابة، فيظهر الإنسان المهجري ككائن يبحث عن اعتراف، لا عن شفقة، وعن حضور لا عن اندماج قسري.
أدب المهجر لم يكن مجرد تعبير فردي عن تجربة ذاتية، بل أسهم في تجديد الأدب العربي شكلاً ومضموناً. فقد حمل معه روح التمرد على القوالب التقليدية، ودعا إلى تحرير الفكر واللغة من الجمود، وإلى الانفتاح على الإنسان بوصفه قيمة عليا. وقد انعكس هذا التوجه في النزعة الإنسانية الواضحة في كثير من النصوص المهجرية، حيث تتراجع الحدود الضيقة لصالح رؤية كونية ترى الإنسان قبل الوطن، والحرية قبل الانتماء المغلق.
الزمن والهجرة
ورغم اختلاف الأزمنة وتبدل أشكال الهجرة، ما يزال أدب المهجر حاضراً اليوم بقوة، وربما أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فالعالم المعاصر يشهد موجات نزوح وهجرة غير مسبوقة، تحمل معها أسئلة الهوية والانتماء والذاكرة نفسها. ويجد الكاتب المعاصر، مثل أسلافه، نفسه ممزقاً بين أمكنة متعددة، وهو يحاول أن يصوغ سرديته الخاصة في عالم سريع التحول.
إن أدب المهجر، في جوهره، هو أدب البحث عن الذات في مرآة الآخر، وأدب محاولة التصالح مع الانكسار دون إنكاره. هو كتابة تنبع من الشعور بالفقد، لكنها لا تستسلم له، بل تحوله إلى طاقة إبداعية قادرة على مساءلة العالم وإعادة تخيّله. وبين صراع الهوية وحنين العودة، يولد نص صادق، يحمل وجع الإنسان وأسئلته، ويمنح القارئ فرصة للتأمل في معنى الوطن، ومعنى أن يكون الإنسان وفياً لذاته، أينما كان.
وإذا تعمقنا أكثر في بنية أدب المهجر، سنجد أن الاغتراب فيه لا يقتصر على المكان، بل يمتد ليشمل الوعي والذاكرة واللغة والرؤية إلى المستقبل. فالمهاجر يعيش غالباً قطيعة زمنية خفية، إذ يتوقف الزمن في داخله عند لحظة الرحيل، بينما يستمر في الجريان خارجه بلا انتظار. هذه القطيعة تجعل الكتابة محاولة دائمة لردم الفجوة بين زمنين، زمن داخلي مثقل بالذكريات، وزمن خارجي لا يعترف بالماضي إلا بقدر ما يخدم الحاضر. ومن هنا يصبح النص المهجري وثيقة مقاومة للنسيان، وسجلاً شخصياً وجماعياً في آن واحد.
الهجرة والإنتماء
كما أن أدب المهجر يكشف بعمق عن هشاشة مفهوم الانتماء، ويعيد طرحه بوصفه تجربة شعورية لا شعاراً جاهزاً. فالمهاجر قد يحمل جنسية جديدة، ويعيش سنوات طويلة في وطن بديل، لكنه يكتشف أن الانتماء الحقيقي لا يُمنح بالوثائق، بل يُبنى عبر الإحساس بالأمان والقبول والاعتراف. هذا الإدراك يخلق نوعاً من الحزن الصامت في النصوص المهجرية، حيث يبدو الكاتب وكأنه يسكن العالم كله، ولا ينتمي إليه بالكامل. ومع ذلك، فإن هذا الحزن لا يخلو من حكمة، إذ يمنح الكاتب قدرة خاصة على رؤية العالم من مسافة، وعلى تفكيك المسلمات التي قد تبدو بديهية لمن لم يغادر مكانه الأول.
وتتجلى خصوصية أدب المهجر أيضاً في نظرته إلى فكرة العودة. فالعودة هنا ليست دائماً خلاصاً، بل قد تكون صدمة أخرى. كثير من النصوص تلمح إلى أن الوطن الذي يُعاد إليه في الواقع لا يشبه الوطن الذي ظل محفوظاً في الذاكرة. الأمكنة تغيّرت، والوجوه غابت، والقيم نفسها ربما لم تعد كما كانت. وحتى إن بقي كل شيء على حاله، فإن العائد ذاته قد تغيّر، ولم يعد قادراً على الاندماج في المكان كما كان من قبل. وهكذا تتحول العودة إلى سؤال مؤلم: هل نعود إلى الوطن، أم نعود إلى أنفسنا القديمة التي لم تعد موجودة؟
من جهة أخرى، يمنح أدب المهجر مساحة واسعة للتأمل في معنى الحرية. فالتحرر من القيود الاجتماعية والسياسية التي دفعت إلى الهجرة لا يعني بالضرورة التحرر من القيود الداخلية. إذ يكتشف الكاتب المهجري أن الحرية مسؤولية ثقيلة، وأن الاختيار المفتوح قد يكون أكثر إرهاقاً من القيد الواضح. هذا التوتر بين الحرية والحنين، بين الانفتاح والخوف من الضياع، يضفي على النصوص المهجرية طابعاً فلسفياً عميقاً، يجعلها تتجاوز حدود السيرة الذاتية لتلامس أسئلة الوجود الإنساني الكبرى.
من هنا، يظل أدب المهجر شاهداً على قدرة الإنسان على تحويل الألم إلى معنى، والاقتلاع إلى فعل إبداعي. إنه أدب لا يبحث عن وطن نهائي بقدر ما يبحث عن صوت صادق، وعن لغة تستطيع أن تحتمل التمزق دون أن تنكسر. وبين المنافي المتعددة، الجغرافية والنفسية، يكتب المهاجر نصه وكأنه يكتب نفسه من جديد، مؤكداً أن الهوية ليست ما نفقده بالرحيل، بل ما نعيد اكتشافه ونحن نسير في طرق لا تشبه خرائطنا الأولى.


